
مقدمة ديوان ( راية النّدى ) .. للشاعر مصطفى الحاج حسين
الأديبة والناقدة: نجاح إبراهيم
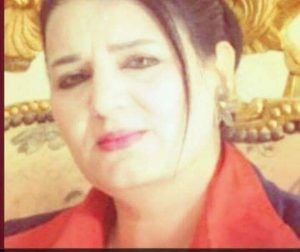
شاعر يشفّ ندى
هل أقولُ
الحقيقة ؟
وأعترفُ أنني أدمنتُ قمحَ قصائدِ الشاعر” مصطفى الحاج حسين” كما يدمنُ الجائعُ المهووس بخبز البلاد ! من أوّل قصيدةٍ له ، أعلنتُ قسمي، ألا يبرحني صدقُ إحساسه ، ولا نبلُ عواطفه ، ولا ألمه العميق ، ولا قلبه المحشو بالنقاء والجراح، ذو الملامح البريئة كقلب يمامة تشتهي الأمان. لن أغادرَ قصائده وإن استعطفتني قصائد تأتي من جهات مختلفة، فهو الشّاعر المُجدّ، المواكبُ لكلّ
نسمة تأتي بالبشارة ، فتزيل ما تراكم من على الأجفان. كلُّ صباح أفتحُ عينيّ لأجدَ الشاعر منكباً ليله على نصّه ، يُطعمه  آخرَ قطرةٍ من الرّوح ، وفي المساء
آخرَ قطرةٍ من الرّوح ، وفي المساء
يختزلُ الوجعَ ليغزله نصاً جديداً يرسله في آخر الأوقات المستغيثة بحفنة هدأة ، وهكذا دواليك..فكيف أغادرُ هذا الترف الموجع؟ على الرّغم من أنّ قلبي رهيف لا يحتمل الألم ، فما فيه يفيضُ ويتنابعُ ؟
فإلى أين أذهب من هذا الحصار الندي؟ وكيف أغادرالاحتفاءات؟
مرات استقبلتُ ما يرسلُ بكاءً صامتاً ، يصعبُ أن أحدّ سيله بأصابع مرتعشة!
ومراتٍ حاربتُ ذلك، بالتجاهل المتعمّد إلى حين، كي أصونَ هذا القلب الصغير من الوجع:
” الآن عرفت
لماذا القمر يدور حول الأرض
إنه يلاحقك
أبصرته كان يسترقُ النظر
يراقب تحركاتك باستماتة
ويلتقط لك صوراً ..”
وما كنتُ أدري أنني أبتعدُ عن الدواء إلى داءٍ ، وما
كان الدّاء إلا الدواء!. وحين كان يتأخرُ بريده وقتاً ، أتذرعُ بالصّبر وأفشلُ في تحمله ، أتذرعُ بالكتابة وأفشلُ، ليس فيها وإنّما بنسيان ما أنتظر، علماً أنني أدرك أنّ الذي أخّر البريدَ، هو بكاء الشاعر، وتعاظم اغتراباته ، وحنينه المغروس في الحبر صفصافاً يدقُّ أجراسه، ليعزفَ سيمفونية القهر والشوق والغُصص، وأعرفُ أنه- كما كلّ مرّة- في حوار مع نحيبِ الجهات ، يحاصره الخرابُ الرّوحي، وأنه يحاولُ أن يصالحَ نفسه لتتواطأ مع ما يشعر به ، لتنبلج قصيدة تسافرُ منه إليّ:
” حاور نحيبَ الجهات
تكدّس خرابُ الأفقِ
في صوتك
وتراكمت المسافاتُ الخائبة
من أجنحتك العرجاء
وهامتْ بك الأوجاع..”
أعرف أنك في هذه الدّائرة، وأتجاهلُ ما أعرفُ لأصبرَ وأنضحَ شوقاً لما يجيئ.
أريد للصفصاف أن يعلن قياماته مع الرّيح، وللكرزِ أن يُزهرَ، وللضوء أن يُثمرَ.
لهذا أودُّ أن أهمسَ في أذنِ الشّاعر، وأكتبَ بشكلٍ غير متعارف عليه في كتابة المقدّمات ، ليشكلَ همسي شاطئناً، أو جسراً يمتدُّ من دهشةِ ما بين عينيّ ودمي اللاهب ، وما بين القصائد المترفة بالألم والرغبة في السلام، وأصداف من أريج محبّة، وأسراب يمامٍ يعلو، ويعلو، ثمّ يحطّ على قلعة الإباء ، يشي بما حمّله الشاعر المنفي بسربالِ الاحتماء إلى أمانٍ مفقود، وداليةِ شوقٍ ، وشجرةِ
بيلسان تسّاقط شموساً وفراشاتٍ وصوتاً معشّقاً بالحبّ ، وكفين فيهما من سنابل البلاد. يا للبلاد! كم فيها من رائحةٍ تعبقُ في قصائده ، تجعلُ القارئَ يسجدُ عند عتباتِها، وفي الصدر تتلى سِيَرٌ، تبدأُ من أوّل رُقمٍ طينيّ، إلى ما بعد دواوين الدّم الظامئ لملحمة الهوية، والوطن الذي يبقى ما بقي الإبداع:
” كلُّ المدائن
خُلقتْ من ضلعكَ
سيقولُ المؤرخُ:
كانت عصية على الغناء..”
فالشاعر يمضي حاملاً الجرحَ ساريةً، يقبعُ الحزنُ في حنجرته ، ويكثر الشوكُ في طريقه ، وعيناه يَسكنهما الصّمتُ ، ويبقى كالقديسين في محراب القصيدة ، يؤرّث عسلَ الكلام، أميراً للحرف في زمن انهياراتِ القيم ، يستمطرُ من نداه كلّ برهةٍ قصيدة، تنقذُ ما يتماوتُ فيه ، تحيي رميمَ الوقت ،ولكن لابدّ من المرورِ بأزقةِ الموت، ودهاليز الألم كي يدلج إلى ساحات الحياة. لا بدّ من العتمة لكي يبهرنا مطلعُ الشمس، لا بدّ من الظمأ كي ندرك عذوبة الفرات ،
فيا:
” قلب النور
ستنتهي المأساة بالفرحة
ويعمُّ الغناء..”
وأنا لستُ أنظرُ أمام مواتك وانبعاثاتك أيّها الشاعر ،وإنّما هي روحي المؤمنة بك ، وبما يتقاطرُ من مداد قصائدك من ندىً، فسيّد الانثيالات أنت ، وحامل راية الندى. وزّع علينا من غدقكَ ما يجعلنا ندهَش :
” وزّع عسلَ الشهقة
على جسم التلعثم الباكي
سيّد العشق أنت
إذ تمطر بالاكتواء
ناسك العفّة الوارفة بالياسمين
ذائع الحبّ النبيل..”
هي قصيدتك المكتظةِ بالوهج ، ونبضك الممتلئ بالشوق، وقدَرك تمشيه فوق الجراح ، يكتبُ لك طريقاً ممتدّاً فوق الدّمع ، لتغني القصيدة الحلم، وتمشط شعرَ الشمس. فمن منكما يستطيعُ مغادرةَ الآخر، وقد سكنتك كأنثاك، وأنت تسكنها خالقاً وباعثاً؟ كلاكما يحتفي بوطنٍ سُقي بروح الله ، لهذا تسامى فيكما ، ورحتما معاً تتباريان على رسمه ، فيجيئُ الوطنُ راعفاُ بالدّم، وتارة بالقضاء والقدر وبآياتٍ من
طهر ، وأخرى من ضوءٍ وعشقٍ وعشبٍ وجرح و..و..ياااه!
مصطفى الحاج حسين!
أيّها الشاعرُ الصّامت ، المُضمخُ بحزنٍ عميقٍ ، تشهد عليه أخاديدُ الوجه ، ومساربُ القلب، والمسافاتُ التي يناظرها كلّ صبح ، والحلم الذي يشكله عند مطالعه ، والوحدة التي تدعوه لأن يكتب. هذا ما جعلك قادراً على سكب ما في ذاتك في القصيدة ،يا أيها الشاعر، الذي يسكب ذاته في قصيدة، فتبعثُ فيها إثارة ودهشة وشمولية ، تبحثُ في كلّ منها عن شكلٍ جديدٍ ، أنت الذي تسألني عقب كلّ قصيدة : هل جئتُ بجديد؟
أظنك تقطف الإجابة من سؤالك لأنه مأزوم مثلك، ولاهثٌ إلى شرفات الشروق. إنك لتأتي بما هوجميل ، شكلاً ومضموناً ، وتُلبس كلّ قصيدة وشاحاً ملوّناً. بالله عليك كم عدد الأوشحة التي صارت في حوزتك؟! هل وصلت الألف ؟ قد اكتمل المهر إذن ..اعقدها واصنع أفقاً من ألوانٍ تضاهي به ألوانَ قوسِ قزحٍ ، لنزفّك إلى حورية
الإلهام التي تنتظرك في (حلب) ، فتؤجج الحدائق والغابات التي تتحرك أمام عيني كلّ متلقٍ؟ أجدك تسأل غير مصدقٍ، أنّ قصائدك تحرّك غابة من الدّهشة والشفافية؟! هي على شفافيتها متعدّدة الطبقات النصيّة ، قابلة لأن توقظ الرّؤى، فتنثالُ القصائد رائحة ولوناً ، بحيث تأخذ المتلقي إلى فضاءاتٍ من ألوان راقصة :
” يا طائر الفينيق عجّلْ
هذا الرّماد فتنة بلادي
هذا الدّم نزيفُ دهشتنا ..
امدد يدك لرائحةِ النهار
فكّ أزرار الشهوة الرّعناء
حطمْ أغلال الموج..”
ثقْ بي ولا تكنْ مثلَ “ماكبث” الذي ظنّ أنّ غابة ” بريام” ثابتة، في حين أنها كانت تتحرّك! وهل كانت زرقاء اليمامة تكذبُ؟!.
تلك قصيدة مصطفى حاج حسين. تقرع أبوابَ الرّوح، فتُدخِل إلينا الفرحَ، والضوءَ، والنبيذَ والوجدَ، تدفعنا لأن نفتحَ أعيننا المندهشة .
وتلك ذاته الشاعرة، المفعمة بصورِ البّهاءِ والجمالِ ،والتي تقفُ حارساً أمام بوّاباتِ الحَرفِ النبيلِ ، والغابات التي تتحرّك فينا ، فهل صدّقت كيف تتحرّك الغابة أيّها الشاعر؟ إنك تعتلي رايةً من ندى ، تبحثُ في كلّ نصّ عن طريقة للخلاصِ والأملِ ، والرّغبة في التوحّد مع النصف الآخر، مع المرأة والاتحاد بها ، لتشكلا كوناً مفعماً بالرّوح والأسرار. هي رغبتك واشتهاؤك الأكيد ، بشغفٍ تكتبُ عنها ،
تمتطي حلمَ اللقاء ، وصولاً إليها، إذ لطالما بوّأتها مكانة رفيعة ، فحضورها يُشبه رؤية ليلةَ القدر، لتأتي القصيدة هاتفة بسحرِها ، تدفع كأس نذرها ، نخب الألوهة العابق:
” ينحني لك نبضي
بخشوعٍ جمّ
يُقبّلُ أصابعَ عطرِك
ويقعدُ فوقَ سجّادة الابتهال
يرنو لعينيك
بعطشٍ طائشٍ
أيتها الأنثى
المخلوقة من نور
في راحتيك يسكنُ لهاثي
ومن على بُعد المدى
يتناهى إليّ ما فيك من بهاء..”
هي المرأة المغايرة، التي تأتي فتأتي معها الأقمارُ والنجومُ والهمسُ المقدّسُ، والفرح بلونِ عشبٍ مندّى ، لا تستطيع فصلها عن عشقك الآخر /الوطن
الذي صعب علينا أن نفرّق بينه وبينك ، وبين حبيبتك. الوطن الذي شكّل لديك هاجساً يتعدّى المسافات، تتراءى لنا نغمات ترصدُ صوراً لداخلك ، إشعاعاً يتنافرُ إلى الخارج ، إلى جسدِ القصيدة ، رافلة به، هاجساً كان بذرة، ثم نبتت، فأورقت، وتجذرت مما ألمَّ بالوطن وبك ، فأثر كلُّ ذلك فيك تأثيراً عميقاً، ولم تستطعْ أن تواربَ تلك الموجات أو تسترها ، حتى تراكمت وانفجرت. تلك هي رحلة هاجسك الأليم ، أن يعود الوطن إليه الأمان ، والبهجة إلى المهجة ، أن يعود إلى أبنائه ، إليك ، طاوياً كلّ اغتراب وغُصّة وضياع. أجدك تصلي مغمضَ العينين، تقولُ في سرّك: ليت هذا يكون. ولكنه لن يكون إلاّ كما أردتَ أن يكون ، في الشكل الذي ترتئيه، والصياغة التي حلمتَ بها. لكن سيبقى الهاجسُ متنامياً، فما لديكَ من نماءٍ غريبٍ في داخلك لن يضمحل ، هاجسك اللا ينفك يتوالد ، آنى له أن يغادرك؟! .
أتدري لم؟ لأنك شاعرٌ مسكونٌ بالأوجاع وبالندى. ولأنّ عندك رؤية وشعرٌ ، وهل ثمّة شعر دونها؟ كثيرون من الشعراء لا تتوفر لديهم فيما يكتبون ، لهذا نجدهم أمواتاً، بينما أنت ستبقى على قيد حياة . لأنك زاخرٌبها ، لديك الشمول ، والعمق
والحلم، والقدرة المذهلة على التخيّل ، إضافة إلى الموقف الواعي. وعلى الرّغم من أن الرّؤى الغالبة على قصائدك هي رؤى سوداء ، بيد أنّ الأمل والبشارة موجودان في عشقك الكبير لتلك المعشوقة، التي استطاع أن تماهيها بالوطن، وبالمدينة الأثيرة لديك ألا وهي حلب.، حيث تأتلق كمكان داخل القصيدة ، ولأنها واقعة في ضيم الإرهاب ، فالشاعر الذي تكونه قادرٌ على التأثير والاقناع ، ودلالات المكان لا تغادر عشقه له، فمنه تأتي البداية وإليه تنتهي الطرق والدروب، وما بين الأمرين رحلة اغتراب وضياع وألم وحنين وأمل كبير بحجم حلب . ولعل ما هو لافت، ثمة وحدة عضوية في كل قصة ،جلية الملامح ، يانعة الاشراق ، مكللة بلغة متجدّدة ، تسعى كما كلّ مرّة بحثاً عن الانتقاء واختيار اللغة المعبّرة ، والصورة المكتحلة بالانبعاث، لتأتي القصيدة بعشقٍ تحبّر بياضه الأليم، بما يمتلكُ من فطرةٍ شعريّة ، وأفكارٍ منمّشة بجراحِ الواقع وغبار المعاناة ، وشقوق الوقت ، يكتبها بسهولة ودون افتعال أو احتباس، تهدلُ في وجداننا دون استئذان ، راتعة بجمالياتها ، نلامسُ فيها بساطة التعبير، على الرّغم من رمزيتها وعمق إيحائها ، ولعل ما يُدهشُ أنها تختمُ دنانَ حضورها بالتفاؤل والحبّ السّامق.
فيا أيّها المصلوبُ على رايةِ الندى !كلّ القصائدِ تتقاطرُ منك ، خطواتٍ في طريق
الضّوء، لتجعلَ منك فاتحاً قديماً على بوابات الألم النبيل . كلّ الأقصية تأتيك، أنت الذي تغرّب وما كان يرغب ، فجددتك القصائد انتماء كل حين إلى الجذور ،
وصارت العناوين تأخذ عناوينها بفخرٍ ، حملت سيفاً لتواجه به ظمأ الرّحلة ، وأشواك الطريق وعراء الطريق، فنبتَ قدّاح على خدّيه ، ورفعتَ وأنت مفعمٌ بالجراح راية الندى. ياصاحب الندى ! سلامٌ لقصائدكَ التي أحالت السّكاكين إلى عشب وندى، والظلمة إلى فجرٍ، ومواسمَ الحداد إلى أغنيات خضراء. لاهفة كنتُ وسأبقى إلى سحر عبارتك ، إلى مطرك اللا يقف ، إلى عطاءاتك ، أحسني حين أقرأ قصيدة ما لك ،أنني أقرأ شعراً له سحر وغواية، منذ عهد آدم واغواءات الشجرة وهي تصعد في شرايين الشهوات، تحملها في جيناتك ، تشعلها ناراً وإبداعاً
لا ينطفئ . أتخيلك تطرق برأسك حياءً ، بيد أنني ما غاليتُ بما باحَ حبري في حقِّ قصائد لها اشتعالُ الندى.

